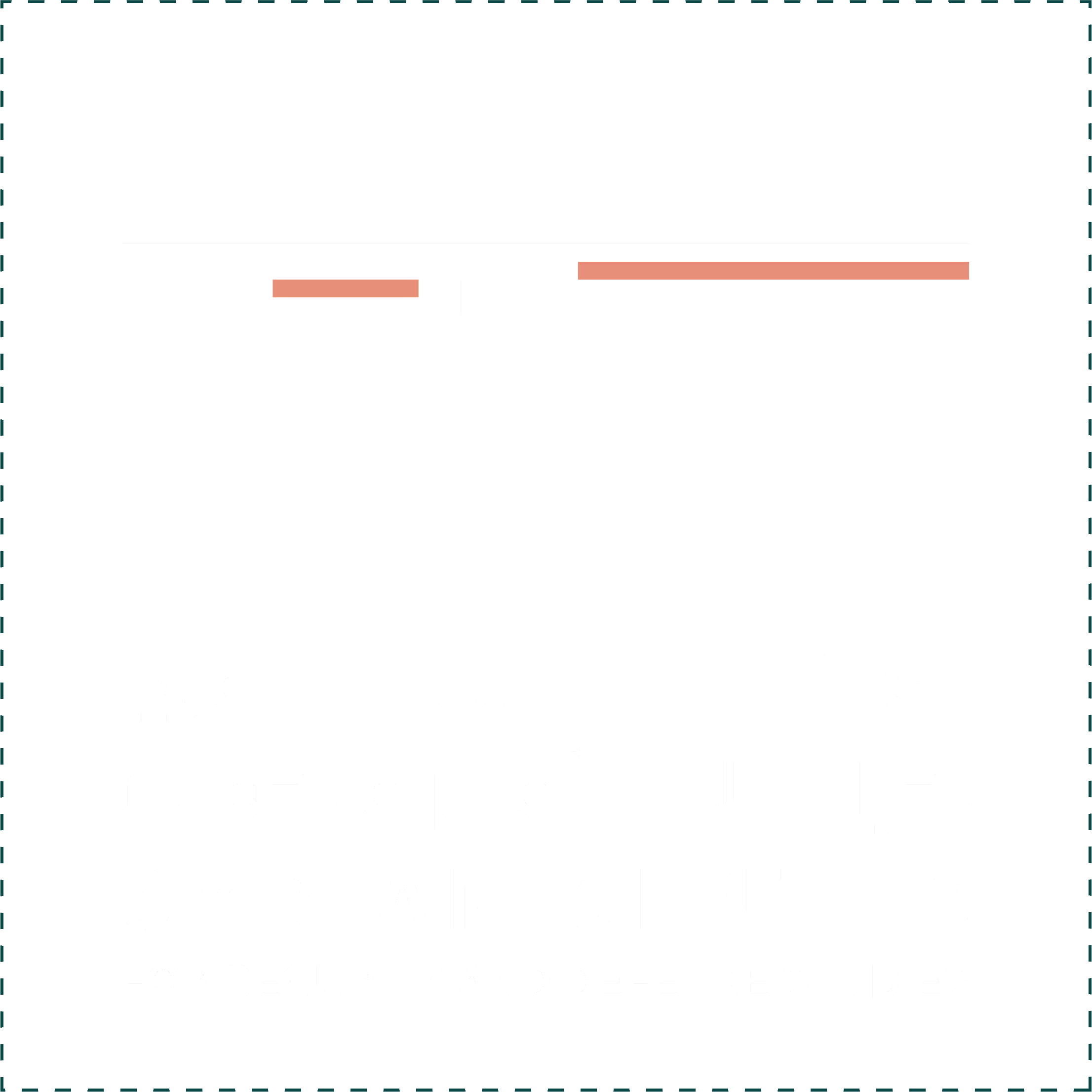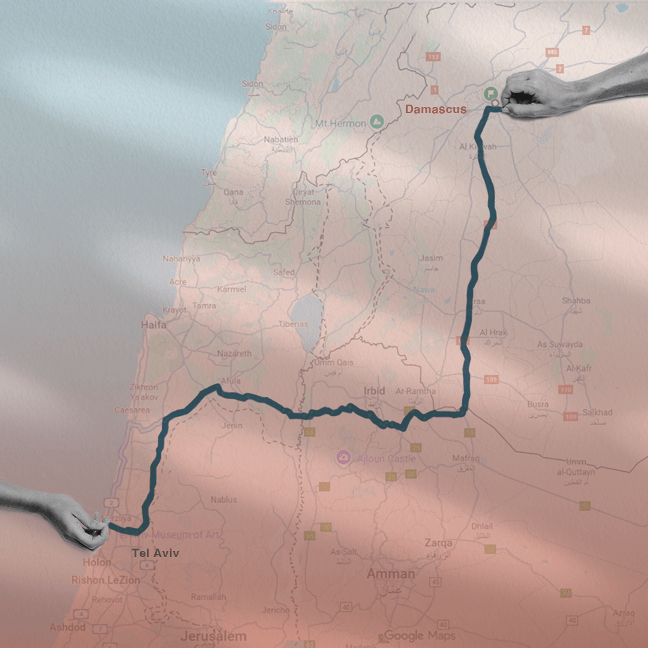ورقة السياسات
الكاتب: محسن المصطفى
ملخص تنفيذي
تمهيد
لا تزال سوريا تتلمّس خطواتها الأولى نحو النهوض بعد عقودٍ من الحكم الديكتاتوري وعقدٍ ونصف من حرب مدمّرة خاضها بشار الأسد ونظامه ضد ثورة الشعب منذ عام 2011. خلال أقل من عام، استطاعت
كلمات مفتاحية
العلاقة المدنية العسكرية - الإعلان الدستوري - مجلس الأمن القومي - الجيش السوري - الانتقال الديمقراطي - نموذج الوصاية - نموذج الوكالة - إصلاح القطاع الأمني - نزع السلاح - الوحدة الوطنية
سبق مؤتمر النصر اتخاذ خطوات عملية لتفعيل وزارة الدفاع وإعادة تشكيل الجيش، تمثلت في تعيين وزير للدفاع ورئيسٍ للأركان، واستحداث جهاز للاستخبارات العامة، والعمل مباشرة على توحيد الفصائل الثورية والجيش الوطني ضمن التشكيلة الجديدة للجيش السوري. تعكس هذه الخطوة منطق الغلبة والرغبة بإنهاء الحالة الفصائلية التي كانت تهدد بتفجّر الصراع مجدداً، لا سيما بعد معركة "ردع العدوان" التي أطاحت بالأسد ونظامه2.
لاحقاً، في 12 آذار/مارس 2025، أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم 5 لعام 2025، القاضي بتشكيل مجلس الأمن القومي3، وذلك قبل يوم واحد من إصدار الإعلان الدستوري4، نظراً لارتباط المجلس بالمادة 41 من ذلك الإعلان، التي نصّت أيضاً على دور المجلس في إعلان الطوارئ والتعبئة. كما حددت المادة 9 من الإعلان مهمة الجيش، وحصرت السلاح بيد الدولة، مؤكدةً على مبدأ احتكار القوة ضمن إطارٍ قانوني يحمي السيادة وحقوق الإنسان5.
مع تلك التطورات بدأت أولى ملامح العلاقات المدنية العسكرية بالتشكل في سوريا الجديدة؛ قيادة مدنية، وفصل للسلطات، بانتظار تحقيق التعددية السياسية، وإشراك المجتمع المدني، ويمكن القول إن هذه هي الشروط الرئيسية لعلاقات مدنية عسكرية ناجعة6. ورغم غياب تعريف موحد لمفهوم "العلاقات المدنية العسكرية"، يمكن اعتبار أنها نمط أو أنماط توزيع السلطة والتفاعل بين المؤسسة العسكرية من جهة، والسلطات المدنية والمجتمع من جهة أخرى، بما يضمن خضوع الجيش للقيادة السياسية الديمقراطية مع الحفاظ على استقلاليته المهنية وفعاليته القتالية7.
وعليه تسعى هذه الورقة إلى تحليل الوضع الراهن للعلاقات المدنية العسكرية في سوريا الجديدة، واستكشاف سبل تطويرها بما يضمن توازنها وصحتها، بحيث تُسهم في ترسيخ الحكم الرشيد وتمنع إعادة إنتاج العنف. كما تنطلق الورقة من المقاربة الدستورية، مروراً بهيكل مجلس الأمن القومي، ثم تستعرض نماذج نظرية (الوصاية والوكالة)، لتخلص إلى تصور شكلٍ جديد للعلاقة المدنية العسكرية خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها.
الإعلان الدستوري ومجلس الأمن القومي
حدّد الإعلان الدستوري عدداً من المواد التي ترسم معالم العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، ونصّت المادة 9 على أن "الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامتها ووحدة أراضيها. بما يتوافق مع سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وأن "الدولة وحدها هي التي تنشئ الجيش ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويُحصر السلاح بيد الدولة"8.
كما نصّت المادة 32 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وأسندت له المادة 41 صلاحية إعلان التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن القومي. وفي حالات الخطر الجسيم الذي يهدد الوحدة الوطنية أو يعطّل عمل مؤسسات الدولة، يُسمح له بإعلان حالة الطوارئ، جزئياً أو كلياً، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في بيان الى الشعب، بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يمكن تمديدها إلا بموافقة مجلس الشعب9.
بدورها، نصّت المادة 42 من الإعلان على أن تتولى السلطة التنفيذية مسؤولية بناء المؤسسة الأمنية، بما يعزّز الأمن الداخلي ويحمي حقوق المواطنين وحرياتهم، مع العمل على تأسيس جيش وطني احترافي، مهمّته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وخدمة الشعب بإخلاص، ضمن التزام كامل بالقوانين النافذة. حيث يتكامل هذا النص مع الفقرات السابقة ليؤسس إطاراً قانونياً ينظّم العلاقة بين الجيش والدولة، ويوجّه المؤسسة العسكرية نحو الالتزام بالوظيفة المهنية لا السياسية.
بالمقابل، حدد قرار تشكيل مجلس الأمن القومي، رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية، وعضوية كل من وزير الخارجية؛ وزير الدفاع؛ مدير الاستخبارات العامة؛ وزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يُعيّنهما الرئيس، ومقعد تقني تخصصي يُعيّنه أيضاً. كما حدد القرار أن تتم مهام المجلس وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات10.
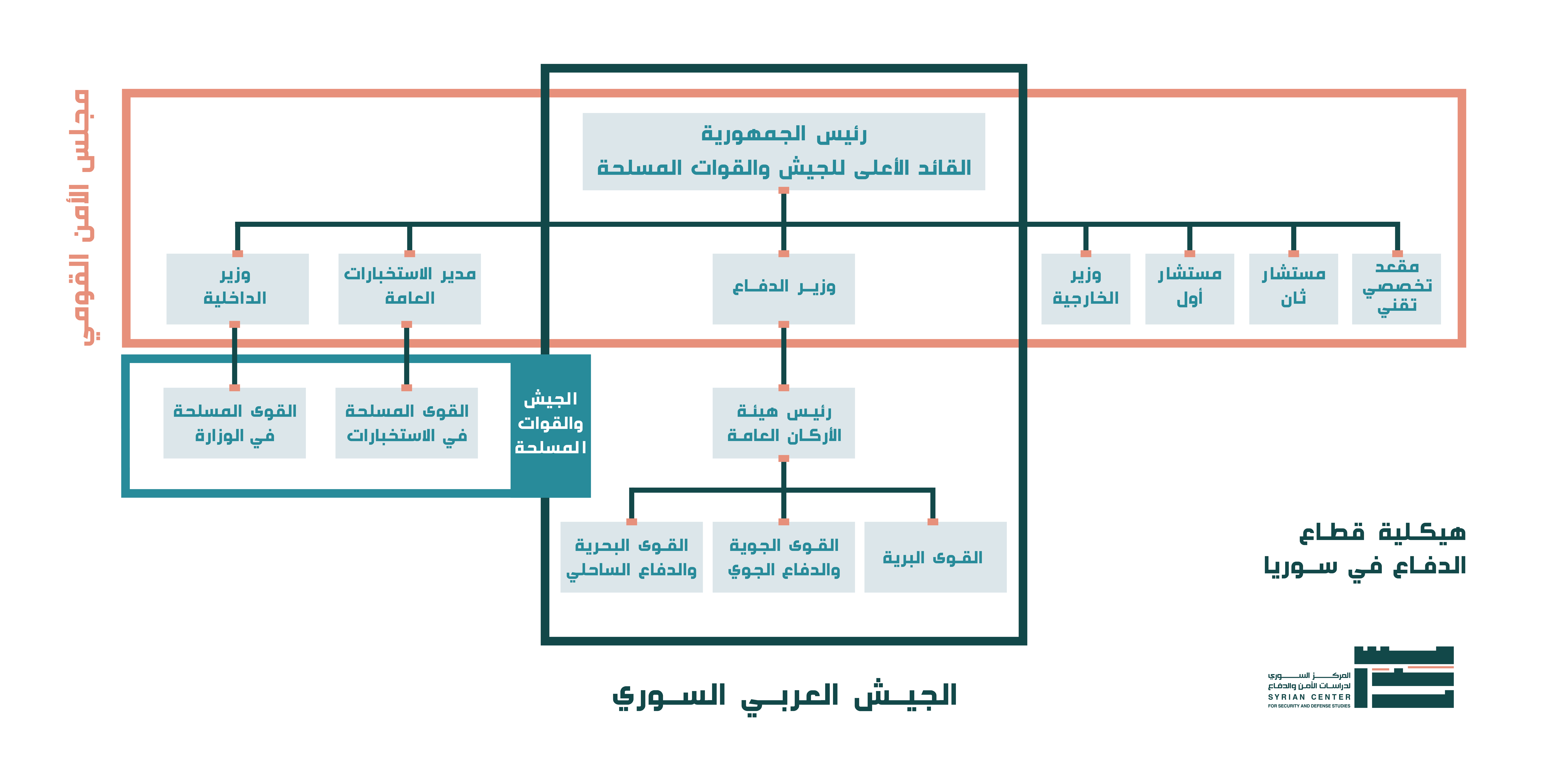
تعكس صياغة الإعلان الدستوري توجهاً نحو السيطرة المدنية الموضوعية11 عبر احتكار الدولة استخدام القوة وتقييد إعلان الحرب والطوارئ بإجراءاتٍ وضوابطٍ مؤسسية. ومع أنّ رئاسة رئيس الجمهورية المجلس تُعدّ أمراً طبيعياً ومتسقاً مع موقعه الدستوري، إلا أن حصر تشكيل المجلس وتعيين أعضائه بقرارٍ رئاسي منفرد من دون إطارٍ تشريعي واضح (لاحقاً حين يتم تشكيل مجلس الشعب)، يخلق قابليةً للانزلاق نحو سيطرةٍ ذاتية تُسيّس المؤسسة العسكرية ما لم تُستكمل بمنظومة توازنٍ ورقابة مؤسسية.
في الوقت ذاته، قد يبدو هذا الترتيب ضرورياً، بل طبيعياً في ظل المرحلة الانتقالية الحالية والممتدة إلى ما تبقى من 5 سنوات مُعلنة سابقاً. ومع ذلك، ينبغي الحذر من تحوّل هذه الترتيبات الانتقالية إلى بنى دائمة تحت ذريعة الضرورة؛ إذ قد تُفضي إلى تمدد صلاحيات استثنائية بشكل غير مقصود، ما يفرض وضع ضمانات زمنية وتشريعية للحد من هذا الخطر.
ينبغي، لتفادي هذا المنزلق، ترسيخ وتثبيت خطوط فصلٍ واضحة بين القرار السياسي والوظيفة المهنية للجيش في الدفاع عن الدولة وسيادتها وتنفيذ المهام العسكرية المقررة قانونا، ويحظر عليه التدخل في الشؤون السياسية أو الحزبية أو الاقتصادية بالتوازي مع ضبط قنوات المشورة العسكرية، وتكريس مبدأ المساءلة أمام مجلس الشعب والرأي العام، ولو بشكل مرحلي. وعلى المدى المتوسط، تبرز الحاجة إلى توسعة عضوية مجلس الأمن القومي، وإصدار قانون خاص به يحدّد صلاحياته بدقة، ويضم وزراء وقيادات أخرى من الضروري إشراكها وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان العامة.
على سبيل المثال، يضم مجلس الأمن القومي المصري طيفاً واسعاً من مسؤولي الدولة، وتُحدّد أهدافه ومهامه بوضوح وفق قانون إنشائه12. على غرار النموذج المصري، يمكن النظر أيضاً إلى التجربة التونسية التي اعتمدت مجلساً وطنياً للأمن في ظل الدستور الجديد بعد الثورة، حيث خصص له دور استشاري وارتبط بالسلطة التنفيذية دون أن يحتكر القرار الأمني13. أيضاً اعتمدت تركيا نموذجاً مغايراً يقوم على تقليص دور الجيش تدريجياً في صنع القرار السياسي بعد المحاولات الانقلابية، ما يبيّن أهمية السياق السياسي المحلي في تحديد البنية المثلى للعلاقات المدنية العسكرية14.
نماذج من العلاقات العسكرية المدنية
تقدّم أدبيات العلاقات المدنية العسكرية مقاربتين تحليليتين شائعتين لفهم دينامية السلطة بين القيادة المدنية والمؤسسة العسكرية: نموذج الوكالة ونموذج الوصاية. حيث يفترض نموذج الوصاية تقارباً في الغايات بين الطرفين ويصوغ العلاقة كشراكةٍ متمركزةٍ حول هدفٍ أو أهداف معلنة، يتصرّف فيها القادة العسكريون كـ "أوصياء" على الأمن والقيم الدستورية ضمن حدود السياسة والقانون. أما نموذج الوكالة فينطلق من فرضية تباينٍ في الأهداف واختلالٍ في المعلومات بين “الأصيل” (المدني) و“الوكيل” (العسكري)15.
بشكل عام، لا يُقدّم أي من النموذجين “وصفة جاهزة”، بل عدستين تحليليتين: الأولى تُبرز قوة التوافق المؤسسي حول الهدف أما الثانية فتُنبّه إلى كلفة الاختلالات والرقابة. وبالانطلاق منهما، يمكن فهم كيفية تأثير فرضيات مثل مستوى الثقة، وهيكل القرار، وتدفقات المعلومات في رسم شكل العلاقة المدنية العسكرية المرغوب دراستها في السياق السوري وفق ما يلي:
1- نموذج الوصاية: شروط التمكين ومكاسب الانضباط وحدوده
تُعرّف مقاربة الوصاية العلاقةَ المدنية–العسكرية بوصفها شراكةً متمركزةً حول أهدافٍ وطنيةٍ مشتركة، يتصرّف فيها القادة العسكريون كـ "أوصياء" على الأمن والقيم الدستورية، لا كوكلاءَ يجب إخضاعهم للرقابة الدائمة. تفترض المقاربة تقارباً في الغايات، وتستند إلى آلياتٍ داخلية مثل صنع القرار المشترك وتبادل المعلومات، مع عناصر داعمة كالثقة والسمعة والاستقرار والاستقلال المهني المحسوب.
تُسقِط الحالة السورية هذه المقاربة على واقعٍ انتقالي يتشكّل فيه جيشٌ جديد بعد حلّ البُنى السابقة، وتُصاغ فيه صلاحيات الرئاسة ومجلس الأمن القومي في ظل إعلانٍ دستوري مؤقّت. يوفّر هذا السياق نقطة انطلاقٍ مواتية للوصاية حين تُفترض ثقةٌ مطلقة بين القيادة المدنية والعسكرية؛ إذ يُعاد توجيه مركز الثقل من مراقبة الأشخاص إلى تماسك الهدف أو الأهداف هنا، وهي: احتكار الدولة القوة، إنهاء الفصائلية، حماية الحدود والسيادة، وإعادة بناء الشرعية عبر الأداء الأمني المنضبط.
تُعيد هذه المقاربة تشكيل ديناميات القرار وتدفق المعلومات، يقتضي المنطق الوصيّ أن تُنتَج القرارات الكبرى عبر مداولاتٍ مشتركة داخل منصةٍ سياسية–أمنية عليا، وأن تتدفّق المعلومات تشغيلياً على نحوٍ يُقلّص فجوات الفهم بين المدنيين والعسكريين16. يعزّز ذلك هويةً مهنيةً جامعة للجيش الوليد، ويرسّخ صورة المؤسسة كحارس على الأهداف الوطنية لا كذراعٍ تنفيذيةٍ تريد نفوذاً سياسياً17.
تولّد الوصاية مكاسب مباشرة حيث تُخفِّض منطق الارتياب المتبادل الذي غذّته سنوات التسييس والأيدولوجيا والولاءات الموازية خصوصاً في حال دمج "قوات سوريا الديمقراطية" داخل الجيش، وتُسند بناء الجيش إلى شرعية أداء تُقاس بالانضباط واحترام القانون، لا بالاصطفافات. تُسعف كذلك إدارة الملفات الحسّاسة كبرامج إصلاح القطاع الأمني "SSR" وكذلك نزع السلاح ودمج المقاتلين "DDR"، ضبط الحدود ضمن إطار هدفٍ واحد، فتمنع تشتت الجهود بين مراكز قوى متباينة18.
مع ذلك، تُواجه الوصاية حدوداً بنيوية وسياقية. يُهدّدها إرثُ المركزية التنفيذية؛ إذ قد تنزلق الشراكة إلى تبعيةٍ شخصية إذا تعذّر تحويل الثقة المطلقة إلى قواعدَ إجرائية راسخة. ويضغط عليها اقتصادُ الحرب وشبكاتُه التي قد تُعيد إنتاج ولاءاتٍ مصلحيةٍ داخل المؤسسة الجديدة. ويختبرها تباين التوقعات المجتمعية بين أمنٍ سريعٍ وحقوقٍ مُصانة؛ فكلما زادت الفجوة، زادت قابلية الخطاب العام لإعادة تسييس الجيش.
وتتعقّد المعادلة بوجود روافع خارجية )دعمٌ دولي، حدود نشطة) قد تدفع المؤسسة العسكرية إلى توسيع دورها خارج نطاقها المهني إن لم تُحسَم الحدود المفاهيمية بين الأمن والسياسة.
تطرح الوصاية سؤال الاستدامة بعد المرحلة الانتقالية حيث تحتاج هذه المقاربة إلى تحويل الثقة المطلقة الراهنة (بين الرئيس أحمد الشرع وقادة الجيش) إلى ثقافةٍ مؤسسية تجعل الانسجام بين المدني والعسكري نتاجاً طبيعياً لهيكل القرار وتدفقات المعلومة والهوية المهنية، لا محصلةَ علاقاتٍ شخصية باعتبار أن الأشخاص وعلاقاتهم زائلة أما المؤسسات فباقية. وتستدعي في المآل النهائي تكييفاً دستورياً دائماً يُبقي الجيش مهنياً ويمكّن القيادة المدنية من إدارة الأمن على أساس الغاية لا على أساس إدارة الولاءات19.
بشكل عام يمنح نموذج الوصاية سوريا الانتقالية لغةً مشتركةً للهدف يُعاد عبرها تعريف أدوار الفاعلين وحدودهم؛ ويقدّم إطاراً يُحوّل الثقة المطلقة بين القيادتين إلى قوة جاذبة تنظّم القرار والمعلومة والهوية المهنية. لكنه يظلّ حساساً لعوامل الانزلاق نحو الشخصنة والمركزية، ولضغوط الواقع الراهن والتوقعات المجتمعية والتدخلات الخارجية، ما يجعله واعداً لكنه مطالبٌ بإسنادٍ مؤسسي كي لا يتحوّل مع الوقت إلى علاقةٍ رمزيةٍ تُدار بالاستثناءات.
2- نموذج الوكالة: هندسة رقابية وكلف سياسية/إدارية ومجالات الملاءمة
يعرّف نموذج الوكالة العلاقةَ المدنية العسكرية باعتبارها علاقة أصيل/وكيل مع اختلالٍ في المعلومات وتباينٍ مفترضٍ في الأهداف. الأصيل (القيادة المدنية) يسعى إلى مواءمة سلوك الوكيل (الجيش) عبر المراقبة والإنفاذ والحوافز/العقوبات لتقليل أخطار "التلكؤ" مقابل "العمل"20. تصورُه طارد، والقوى تتجه إلى الأطراف ما لم يمسك الأصيل مركز المنظومة بالمراقبة21؛ وهو بذلك موروث بيئته الأصلية وتظهر حدوده لأن الوكيل غير قابل للاستبدال فعلياً بسهولة فهو قائم بحد ذاته قبل الأصيل وبعده.
في انتقالٍ يعقب حلّ الجيش السابق وتكوين مؤسسةٍ جديدة تحت قيادةٍ مدنيةٍ دستورية، يُنتج هذا النموذج هندسةً رقابية تحكم العلاقة: تقارير، امتثال، قنوات أوامر عمودية، مقاييس أداء تُستخدم للإنفاذ. حتى مع افتراض ثقةٍ مطلقة بين القيادتين المدنية والعسكرية، يبقى منطق الوكالة يقوم على إدارة الشكّ لا على ترسيخ الهدف؛ إذ تُعرِّف العلاقة بوصفها إدارة مخاطرة سلوكية أكثر من كونها شراكة متمركزة حول غاية مشتركة.
الأثر على صنع القرار، يزحزح نموذج الوكالةُ مركز الثقل من المداولة المشتركة إلى الامتثال: يقلّ هامش المبادرة المهنية للوحدات، ويزداد الميل إلى التحكّم التفصيلي المفرط "Micromanagement" و "الحذر البيروقراطي"، فتتباطأ الاستجابة في الملفات التي تتطلب سرعةً وتكيّفاً (ضبط حدود، تفكيك شبكات السلاح، مواقف داخلية حساسة)22.
الأثر على المعلومة، يُفضِّل النموذجُ التغذية الراجعة العمودية على المشاركة الأفقية: تُصاغ التقارير لتلبية مؤشرات الامتثال أكثر من إغناء الفهم المشترك للموقف. ينشأ حافزٌ لتنسيق المعلومات أو تجميلها تجنباً للعقوبة/الإقالة، وتظهر قنواتٌ خلفية بين الوكالات المدنية والعسكرية لتجاوز سلسلة القيادة الرسمية، ما يوسّع الفجوات بدلاً من تقليصها.
الأثر على الهوية المهنية، حيث يميل الضباط إلى رؤية أنفسهم منفذين تعاقديين لا أوصياء مهنيين؛ فيتعاظم النفور من المخاطرة والتمسّك الحرفي بالإجراءات على حساب نتائج المهمة23. ومع إرث اقتصاد الحرب وشبكات الولاء، يمكن لثقافة الامتثال الشكلي أن تتعايش مع سلاسل موازية وتمويلٍ موازٍ يختبئ خلف نجاح مؤشرات الورق.
الكلف السياسية والإدارية، يتطلب نموذج الوكالةُ جهازاً رقابياً ضخمـاً (تفتيش، مدققين، محامين، مصفوفات امتثال24) ما يرفع كلفة الإدارة ويُولّد احتكاكاً بيروقراطياً دائماً مع وزارات مدنية أُخرى (الداخلية، العدل، المالية). كما يزيد خطر التسييس العلني للخلافات المهنية لأن المراقبة تتحول بسهولة إلى أداة صراعٍ سياسي.
مساحات الملاءمة والقوة، رغم حدوده، يوفّر نموذج الوكالة وضوحاً حاداً للمساءلة في حالات الخلل أو الاختراق أو بقايا الفصائلية؛ ويُنتج لغة ضبط قابلة للقياس على المدى القصير، ما قد يردع الانحراف المؤسسي ويُسعف توحيد سلسلة القيادة بسرعة في لحظات الارتجاج الأمني.
قابلية الانحراف في السياق السوري، تتفاقم اختلالاته في حالة تعدد الأصائل وغياب سوقٍ للوكلاء، ولكن حتى الآن الأصيل واحد (الرئيس أحمد الشرع) والوكيل واحد (الجيش)، ولكن يقبع الخوف مستقبلاً على المدى الطويل، حيث يمكن أن ينقلب المنطق على نفسه: إمّا أن يستولي الوكيل على أدوات المراقبة عبر نفوذه، أو أن يُقيد الأصيل ببيروقراطية الإنفاذ بما يعطل صنع القرار. وفي الحالتين، تتآكل الثقة المعلنة، ويزداد الاعتماد على الاستثناءات.
يُعرّف نموذج الوكالة العلاقةَ كصفقةٍ عاليةِ الرقابة بين طرفين ذوي أهدافٍ متباينة. في سوريا الانتقالية، يمنح الوضوح والمساءلة السريعة في اللحظات الحرجة، لكنه يولّد أيضاً قوى طاردة تُضعف المداولة المشتركة وتبادل المعلومات والهوية المهنية وهي مقوماتٌ لازمة لتثبيت علاقةٍ مدنية عسكرية مستقرة.
الشكل الأمثل للعلاقة المدنية–العسكرية في سوريا
في الواقع لا يوجد شكل أمثل واحد للعلاقة المدنية العسكرية في سوريا، ولكن يمكن التطلّع إلى نموذج مختلط بين الوصاية والوكالة وعلاقة مؤسسيةٍ محكومةٍ بالقانون، تُركّز مركز الثقل المؤسسي على الأهداف الوطنية المعلنة لا في الأشخاص ولا في أدوات الامتثال25.
تفترض هذه الصيغة ثقةً مطلقةً بين القيادة المدنية والقيادة العسكرية، تعمل على تُحوّل هذه الثقة من حالةٍ نفسيةٍ إلى بنيةٍ مؤسسيةٍ تُنظّم القرار والمعلومة والدور. تُعرَّف القيادة المدنية بوصفها مُحدِّدةً للسياسة والقيم والأولويات والموارد، فيما تتموضع المؤسسة العسكرية كجسمٍ مهنيٍ يُنتج خياراتٍ تنفيذيةٍ، ويُنفّذها ضمن الحدود السياسية والقانونية، مع استقلالٍ مهنيٍ محسوبٍ لا يمتد إلى السياسة.
تؤطر هذه الصيغة عملية اتخاذ القرار داخل منصةٍ سياسية–أمنية عليا يتبلور فيها القرار المشترك على القضايا الكبرى، ويُوثَّق فيها الرأي المهني المخالف كآليةٍ لحفظ الخبرة لا كمدخلٍ للنزاع. ويُعاد تعريف تدفّق المعلومات بوصفه مورداً مشتركاً لا أداةَ اصطفاف، فتتشكّل صورةُ موقفٍ موحَّدة تُقلّص فجوات الفهم بين المستويين السياسي والعسكري وتسمح بمواءمة مستمرة بين الغاية والوسيلة.
وتُبنى هوية الجيش على أسس وطنية مهنية محايدة سياسياً، ويجري تثبيت وحدة السلسلة القيادية بلا قنواتٍ موازية، مع ممارسة الاستقلال المهني داخل عقيدةٍ مكتوبةٍ وقواعد اشتباكٍ واضحة تُبقي التنفيذ بيد العسكر وتُبقي الغاية بيد السلطة المدنية.
يستند هذا الشكل إلى شرعية أداءٍ تُقاس بسلامة الانضباط واحترام القانون وحماية الحقوق والجاهزية والفاعلية، لا بشرعية ولاءاتٍ أو توازنات نفوذ. وتُحاط وظيفة الاستخبارات بولايةٍ قانونيةٍ دقيقة ومساءلةٍ مدنيةٍ مؤسسية، ويُفهم الإسناد الأمني الداخلي بوصفه دعماً للسلطات المدنية وتحت مبدأي الضرورة والتناسب. وتُفصل العدالة العسكرية كمسارٍ انضباطيٍ مهنيٍ عن القضاء العادي الذي يختص بالجرائم الجسيمة وحقوق الإنسان، بما يحفظ سمعة المؤسسة ويمنع تسييس أدواتها26.
الخاتمة والتوصيات العامة
تستدعي الحالة السورية علاقةً مدنية عسكرية تُدار بتوازن بين القيادة المدنية والعسكرية وفق مأسسة لا وفق ظروف مؤقتة، ويتطلّب ذلك تعريفاً واضحاً للغايات الوطنية المشتركة وإعلانها في وثيقة معتمدة تُقرّها الحكومة ويصادق عليها
مجلس الشعب، واعتمادها إطاراً ملزماً تُقاس عليه سياسات الأمن والدفاع وأداء المؤسسة العسكرية، بحيث يظلّ القرار السياسي محتفظاً ببوصلة الغاية، فيما تتولّى المؤسسة العسكرية التنفيذ المهني ضمن عقيدة مكتوبة وقواعد اشتباك صريحة. عند هذا المستوى، لا تعود الرقابة العقابية أداةً يومية لإدارة العلاقة، بل تتحوّل إلى ضمانةٍ احتياطيةٍ تحمي الحدود وتُبقي المساءلة ممكنة دون تقويض روح الشراكة.
كما ينبغي تثبيت صنع القرار المشترك كعرفٍ مؤسسي، وأن تُعاد هيكلة تدفق المعلومات بوصفها مورداً عاماً للدولة لا ملكيةً بيروقراطيةً لأي جهاز. يفترض هذا إنشاء صورة موقفٍ موحّدة تُقلّص فجوات الفهم بين المستويين السياسي والعسكري، وتُعطي القرار السياسي مادةً تحليليةً ناضجةً، وتُبقي التنفيذ تحت سقف المهنية لا السياسة.
وتتوطّد شرعية العلاقة عبر الشفافية المقاسة بالأثر لا بالشعارات، من خلال تقاريرَ دوريةٍ عن الجاهزية والانضباط والموازنات والتسليح تُصاغ لأغراض التعلم العام وترسيخ الثقة، وتُرفدها آلياتٌ ماليةٌ تُقفل مسارب التمويل الموازي أو الفساد وتربط الإنفاق الدفاعي بخزانةٍ واحدة. بالتوازي مع إقفال منافذ السلاسل الموازية عبر تثبيت وحدة القيادة ومنع القنوات غير الرسمية، وتكريس الحياد السياسي كقيمةٍ مهنيةٍ لا كشعارٍ أدبي، بما يُبقي الجيش خارج منافسات السلطة ويُحصّن القرار السياسي من إغراءات الاستقواء بالأمن.
كما ترتبط فاعلية العلاقة المدنية العسكرية بمدى تكاملها مع برامج إصلاح القطاع الأمني "SSR" ونزع السلاح وإعادة الدمج "DDR"، وهي عناصر حيوية لضمان تفكيك البُنى المسلحة غير النظامية، واستيعاب العناصر المؤهلة ضمن مؤسسات الدولة، ما يعزز منطق الشرعية ويمنع إعادة تدوير الفصائلية أو تحولها إلى شبكات نفوذ أمنية أو سياسية.
بهذه العناصر ربما يمكن الوصول إلى الشكل الأمثل بوصفه إطاراً عملياً يولّد قوى جاذبة حول الهدف المشترك: يحتكر القانون استخدام القوة من دون عسكرةٍ للسياسة، وتعمل المؤسسة العسكرية كوصيٍّ مهني على أمن الدولة لا كطرفٍ في توازنات النفوذ مع إبقاء قوة الأصيل جاهزة للتدخل. وحين تُترجم الثقة المطلقة إلى قواعدَ ناظمةٍ للقرار والمعلومة والدور مع تُحوّل السلطة إلى مسؤولية تُصبح العلاقة المدنية العسكرية ركيزةً للاستقرار والتحول الديمقراطي، لا هامشاً للمغامرة.
وبالتالي لا تصبح هذه العلاقة تفصيلاً تقنياً في بنية الدولة، بل ركيزةً محورية في بناء سوريا الجديدة. على أن يُعاد تأسيس الأمن بوصفه أداة خدمة لا وسيلة سلطة. بذلك، تُحصَّن الدولة من انتكاسات الماضي، ويُفتح الباب أمام استقرار سياسي مستدام، تستند فيه القوة إلى القانون لا إلى السلاح.
- 1. "مؤتمر النصر": إعلان انتصار الثورة وحل الدستور وحزب البعث والجيش و"الشرع" رئيسياً للجمهورية، شبكة شام، تاريخ النشر: 29/01/2025، رابط إلكتروني: https://bit.ly/3HQfvJU
- 2. المرجع السابق
- 3. "القرار الرئاسي رقم 5 لعام 2025: تشكيل مجلس الأمن القومي"، مؤسسة الذاكرة السورية، تاريخ النشر: 12/03/2025، رابط إلكتروني: https://bit.ly/4n23kIP
- 4. "الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية"، شبكة شام، تاريخ النشر: 13/03/2025، رابط إلكتروني: https://bit.ly/46bmyGj
- 5. المرجع السابق
- 6. معن طلاع، "واقع العلاقات المدنية العسكرية في سورية"، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 17/12/2020، رابط إلكتروني: https://bit.ly/4fUUtGt
- 7. Samuel P. Huntington, “The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations”, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957
- 8. "الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية"، مرجع سابق
- 9. المرجع سابق
- 10. "القرار الرئاسي رقم 5 لعام 2025: تشكيل مجلس الأمن القومي"، مرجع سابق
- 11. السيطرة الموضوعية: (Objective Civilian Control): تخضع الجيش للقيادة المدنية عبر مأسسة المهنية وتقنين الصلاحيات وتثبيت قواعد القرار
- 12. "القانون رقم 19 لسنة 2014، بإنشاء مجلس الأمن القومي"، منشورات قانونية، تاريخ النشر: 24/02/2014، رابط إلكتروني: https://bit.ly/4mEONDg
- 13. "أمر حكومي عدد 70 لسنة 2017، مجلس الأمن القومي"، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن في تونس، تاريخ النشر 19/01/2017، رابط إلكتروني: https://bit.ly/4fYasn7
- 14. بينار تانك، "دروس من المحاولة الانقلابية في تركيا"، صدى/مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر: 11/08/2016، رابط إلكتروني: https://bit.ly/4mvgApw
- 15. Kevin F. Krupski, “Who’s the Boss? Defining the Civil–Military Relationship in the Twenty-First Century”, Military Review, Publish Date: Jan–Feb 2023, Link: https://bit.ly/3HW9VFM
- 16. William E. Rapp, “Civil–Military Relations: The Role of Military Leaders in Strategy Making,” Parameters 45, no. 3 (2015). USAWC Press/DOI
- 17. Samuel P. Huntington, “The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military”, Ibid
- 18. “Inter-Agency Working Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR)” United Nation, Link: https://bit.ly/4oNJiDA
- 19. Samuel P. Huntington, “The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military”, Ibid
- 20. Peter D. Feaver, Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil–Military Relations (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003)
- 21. Kevin F. Krupski, “Who’s the Boss? Defining the Civil–Military Relationship in the Twenty-First Century”, Ibid
- 22. William E. Rapp, “Civil–Military Relations: The Role of Military Leaders in Strategy Making”, Ibid
- 23. Samuel P. Huntington, “The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military”, Ibid
- 24. ويقصد بها أدوات تنظيمية تُستخدم لتتبع مدى التزام العسكريين بجملة من المعايير أو القوانين أو الأوامر
- 25. Samuel P. Huntington, “The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military”, Ibid
- 26. “Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and Practices” ,DCAF & IPU (Geneva, 2003). Link: https://bit.ly/45QNytm